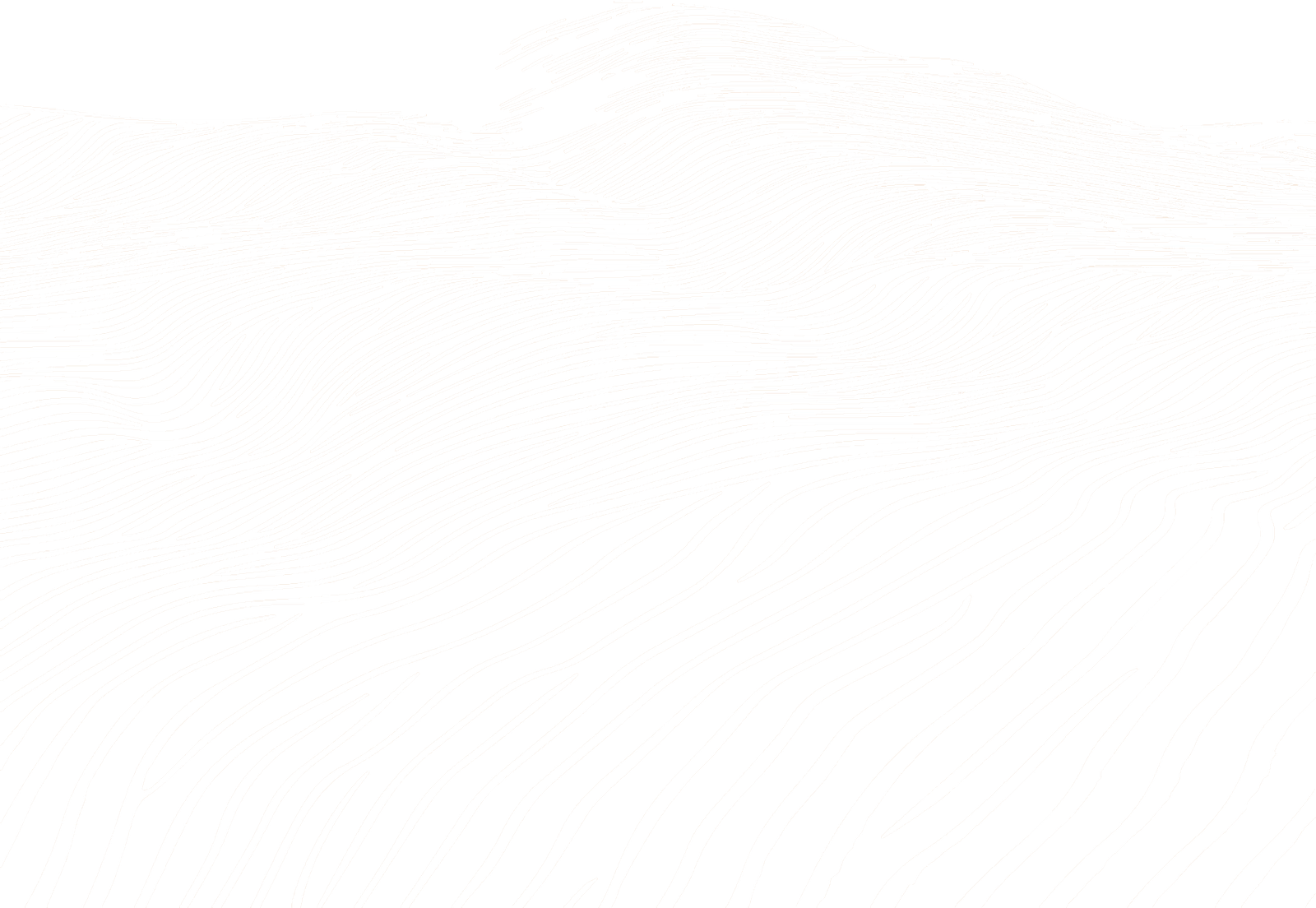مجلس أطلال
هاتان الكلمتان تلخصان حال العمارة والفن والثقافة. الكلمتان إنجليزيتان، وبعيدا عن الاشتقاقات والتفاصيل اللغوية لهما، فإن البورتريه هي رسمة عادة ما تكون لوجه رجل أو امرأة، يزيد ارتفاعها على طول قاعدتها. أما اللاندسكيب فهي عادة ما ترسم منظرا طبيعيا في لوحة يغلب طول قاعدتها على ارتفاعها. الموناليزا والعشاء الأخير هما أهم أعمال ليوناردو دافينشي. الأولى بورتريه والثانية لاندسكيب. الفرق بينهما أن الأولى ترسم ملامح وجه، ولذلك أتت عمودية، أما الأخرى فتمثل مشهدا عاما لسيدنا عيسى وحوارييه من حوله على مائدة الطعام. الأولى تهتم فقط بصاحب الوجه فقط وتركز على أدق تفاصيله. أما الأخرى فهي ترسم المشهد كاملا وتستوعب عددا كبيرا من الشخوص وتهتم بالمشهد والخلفية المصاحبة لموضوع اللوحة.

لأولى تؤكد على الفرد باعتباره موضوع اللوحة، أما الأخرى فتؤكد على السياق بشموليته. ويمكن من خلال هذا المدخل البسيط شرح الكثير من فن الرسم في الغرب ومدارسه وما أكثرها.
بإمكان هذا الطرح على بساطته أن يفسر العمارة الغربية والإسلامية في سياقاتهما بصورة مبسطة وعميقة في آن واحد. العمارة في الغرب بدءا من الرومان ومن تلاهم هي عمارة عمودية. انظر إلى حمامات وملاعب الرومان، وانظر إلى الكنائس في كامل أنحاء أوروبا، تجدها تطاول عنان السماء فراغا من الداخل، وشكلا من الخارج منذ فجر المسيحية وإلى اليوم. واستمع إلى الترانيم والطقوس والشعائر المصاحبة لها. إنها تجسد مكانة نبي الله عيسى ضمن تصور المسيحيين له في عقيدتهم. إنه هو موضوع العمارة وشعائرها، تماما كما هي الفنون المصاحبة لها. لقد كان السيد المسيح هو موضوع العمارة وفنونها في الغرب في معظم تاريخه. هذه عمارة عمودية صريحة. ونظرا لصعوبة الارتقاء بالبناء فقد حفلت العمارة الغربية بعدد وافر من الأساليب والابتكارات الإنشائية التي ساعدت في الوصول بتلك الكنائس إلى أقصى ارتفاع ممكن.
في المقابل، انظر إلى المسجد في العمارة الإسلامية. إنه ممتد بامتداد الأفق. إنه لا يكاد يبرح الأرض إلا بمقدار ما يسمح للناس بالوقوف تحت سقيفته. والسقيفة التي هي أصلا أساس المسجد، وكما يستدل من اسمها، هي مجرد سقف بسيط، تم رفعه فوق عدد من أعمدة جذوع النخل أو مما تجود به مخرجات الصحراء لاتقاء الحر. ليس هناك ما يبرر العمودية في عمارة المسجد. وما اختلاف عمارة المساجد إلا نتيجة لاختلاف أحجام سقائفها، وصحونها، وأعداد مرتاديها. هكذا كان حال المسجد منذ بدايته وحتى اليوم. وتبقى العمارة العثمانية استثناء صريحا لذلك كونها متحدرة من العمارة البيزنطية. وتبقى الاختلافات بين المساجد في كافة أنحاء العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه هي في حجم ارتفاع السقيفة تبعا لمعطيات التاريخ والجغرافيا. ويمكن القول وبكثير من الموضوعية بأنه حتى مع وجود القباب فقد بقي المسجد أفقيا في عمارته، لقد بقيت أبعاده الأفقية أضعاف ارتفاعه.
ليس أكثر وضوحا لهذه الصورة من المساجد في شبه القارة الهندية. المسجد هناك هو أقرب إلى أن يكون صورة أكثر منه منظورا. قاعة الصلاة في المسجد مدججة بالأعمدة المنحوتة من الحجر تحمل سقفا أفقيا، وإن كانت القباب عنصرا رئيسيا فيها لكنها لا تغير من طبيعتها الأفقية.
هذا في العمارة، والحال نفسه ينطبق على فن التصوير في المنمنمات الإسلامية. البورتريه هي لوحة منظور. إنها لوحة يبدو فيها عمق المنظر واضحا، في حين أن لوحة اللاندسكيب يبدو فيها المنظر وكأنه ترادف لطبقات في مستويات بعضها خلف بعض. في المنمنمة لا مكان للعمق. هذا هو حال المنمنمات الإسلامية المتحدرة من مثيلاتها الصينية. هكذا ينسحب المفهوم ليفسر طبيعة الرسم (التصوير) في الفن الإسلامي، تماما كما هو حال المجتمعات الغربية التي هي مجتمعات أفراد ونجوم وشخصيات، كما هي لوحة البورتريه، عكس الصفة الجمعية التي تسم المجتمعات الشرقية.
*أ.د.هاني القحطاني، أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ربما نتذكر رواية الجذور للروائي الأمريكي أليكس هايلي الصادرة عام 1976، والتي تحولت إلى فيلم سينمائي كان حديث الساعة وقت صدوره وما هو أصبح معروفا بالضرورة. غير أن مفهوم الجذور في مقالنا هذا على النقيض تماما من معناه في الرواية وفيلمها. جذر الشيء أصله، والحديث عن الجذور يعني الحديث عن النبات وعن الأشجار تحديدا وخصوصا ما كبر منها. والجذور هي أسس النبات التي تربطه بالأرض ليصبح جزءا منها واستمرارا لها. الجذور في النبات كالقواعد في العمارة وما يتصل بها من أنظمة بناء. وإذا ما تم استعراض تاريخ العمارة الإسلامية على عجل، يمكن القول إنها عمارة جذور بامتياز. فأينما حل الإسلام نشأت هناك عمارة تبدو وكأنها قد ضربت بجذورها عميقا في مكانها الجديد وكأنها نبتة منه. وتاريخ العمارة الإسلامية يؤكد هذه الحقيقة بكل وضوح. ليس أدل على ذلك من البناء الرمز، البناء الخالد، البناء الأقدم في العمارة الإسلامية: قبة الصخرة.

فبالرغم من تأثره بأشكال العمارة البيزنطية إلا أنه بناء إسلامي بامتياز في موضوعه، وفي رمزيته، وفي مقاييسه، وفي عناصره المعمارية، وزخارفه. إنه بناء إسلامي من بابه لمحرابه وكأنه قد سبق جذوره البيزنطية. هكذا كان حال أول معلم إسلامي تماما كما هو حال ما بني بعده من أقصى الجزر الهندوصينية وحتى سواحل الأطلسي. ينطبق هذا على السياقات الثلاثة التي تبنى العمارة الإسلامية في كنفها سواء أكانت حضارة أم دولة أم ثقافة. إن تجذر الشيء يعني رسوخه وانتماءه طبيعيا للمكان. يترتب على ذلك استمرار لفكر الناس واحتياجاتهم وثقافتهم. انظر إلى المساجد في جزيرة سالاويزي في إندونيسيا. إنها أبنية إندونيسية كأنها تخرج من الأدغال قبل أن تكون مساجد. وانظر إلى مساجد الصين (قلب الصين) إنك لا تعرف إن كان البناء مسجدا أم قصرا أم معبدا صينيا. والحال ذاته ينطبق على المعالم الأثربة في أواسط آسيا من حدود منغوليا وإلى كل الدول العربية وصولا إلى بلاد الأندلس. الصورة تكرر نفسها باستمرار: عمارة متجذرة في مكانها تبدو وكأنها امتداد طبيعي له. إن وصف العمارة (أي عمارة) بانتمائها لدين أو مذهب أو عرق أو أي تصنيف كان يعني سيادة ذلك المفهوم الذي تنسب له العمارة باعتباره صفة مهيمنة. هذا هو حال العمارة الإسلامية. إنها عمارة مجتمع وسلطة ودين. إنها استمرار للبناء الاجتماعي والفكري والثقافي لأصحابها. إنها عمارة جذور. هذا ليس حال العمارة الغربية باختلاف مدارسها وحقبها. انظر إلى ما بناه الغرب في مواطنه الجديدة في أمريكا اللاتينية، وفي شرق آسيا، وفي شبه القارة الهندية وأفريقيا. إنك لترى الكاتدرائيات القوطية أو تلك التي تنتمي لعصر النهضة أو تلك التي تعود لليونان والرومان. هذه ليست عمائر جذور، إنها عمائر جلبت جلبا وتعرف أكاديميا بأنها عمائر استعمار (عمارة كولونيال). وإذا سمح لنا هذا المفهوم (الجذور) بصور مجازية منطلقة منه، بإمكان الفرد تصور العمارة الإسلامية دوحة عملاقة ضاربة بجذورها في أعماق الجزيرة العربية ناشرة أغصانها في كافة أنحاء العالم الإسلامي وفي كل إقليم جغرافي، في كل دولة، أثمرت تلك الدوحة بما يتناسب مع هذه البقعة الجغرافية مع أرضها وأناسها تاريخا واحتياجات وثقافة. نعم هناك اختلافات بين العمائر الإسلامية في مختلف الأقاليم لكنها تستظل بفيء تلك الدوحة. تبقى تلك صورة مجازية ويبقى لكل فرد تصوره الذهني لفكرة الجذور باعتبارها خاصية فريدة تميز العمارة الإسلاميه عن مثيلاتها من العمارات وخصوصا العمارة الغربية باختلاف مراحلها. قد لا تكون العمارة الإسلامية من حيث العدد والفخامة والتفاصيل وصلت إلى ما وصلت إليه العمارة الغربية، لكن تجذرها دليل حيويتها واستمراريتها. كل ما تنتظره منا الآن هو ريها بمختلف العلوم وفق طرق جديدة في التعليم والممارسة لكي تنبت من جديد.
أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
بعد استعراض المفاهيم الثلاثة الكبرى التي تدور العمارة (أي عمارة) في فلكها وهي الحضارة، والدولة، والثقافة، أين يندرج يا تُرى مفهوم العمارة الإسلامية؟ وللإجابة المختصرة عن هذا السؤال يمكن القول إنها تندرج تحت كل هذه المفاهيم، ومع ذلك فإنه من المفضل استخدام كل من هذه المصطلحات الثلاثة في سياق تاريخي وجغرافي خاص. فعلى سبيل المثال يمكن القول عن العمارة الفاطمية أو المملوكية، وكلاهما في مصر وبلاد الشام، إنها عمارة حضارة إسلامية، وهي عمارة دولة أيضًا وعمارة ثقافة. في حين يمكن القول إن عمارة الأغالبة في تونس على سبيل المثال، هي عمارة دولة، كما يعكس جامع عقبة بن نافع في القيروان باعتباره الجامع الأب لجوامع شمال أفريقيا.

وبالرغم من أهمية الجامع إلا أن عمارته لا يمكن أن تندرج تحت عمارة الحضارة؛ نظرًا لقِصَر عمر دولة الأغالبة (عمرت قرابة قرن واحد فقط)، وللشكل العام لعمارة الجامع وتفاصيله. وفي غياب الدولة تغيب الحضارة، وتصبح العمارة تعبيرًا عن ثقافة مجتمعات ما قبل الدولة. وتندرج عمائر الظل في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بمختلف مسمياتها وإحداثاتها التاريخية (عمارة تقليدية، عامية، شعبية، إلخ)، تحت مظلة عمارة الثقافة بامتياز. لقد سال حبرٌ كثيرٌ في الكتابة عن مصطلح العمارة الإسلامية. والمصطلح ذاته غربي المنشأ، تلقفه العرب والمسلمون، وبدلًا من أن يضيفوا إليه ويبدؤون من حيث انتهى الغربيون، إذا هم يقفون عند ربط العمارة بالدين، ويذهبون في فهم وتفسير العمارة الإسلامية مذاهب شتى حادت به عن طريق الصواب. إن التفصيل في المصطلح ذاته بحاجة إلى أكثر من مقال، بل هو بحاجة إلى طرح جديد كليةً في حقول معرفية كثيرة تنعكس كلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمارة.
وإلى أن يتم ذلك يبقى موضوع العمارة الإسلامية كمحتوى ومضمون هو الأكثر إلحاحًا بالبحث والتمحيص. وكما تم تقديم المجالات الثلاثة للعمارة أعلاه، يمكن الحديث عن محتويات ومضامين مختلفة للعمارة الإسلامية. لقد عكست عمارة الحضارات الكبرى في تاريخ الإسلام مجتمعات وسلطات استمتعت بقدر كبير من الاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي والحكم الرشيد. وارتقت العمارة في هذه الحضارات إلى حد الكمال. انظر إلى إبداعات أباطرة مغول الهند في مدنهم وقلاعهم وقصورهم وأضرحتهم. إن النظر إلى تاج محل، والعيش في مدينة فاتح بوسكري، والصلاة في جامعها، وكلها في مدينة أجرا، والتنزه في أجنحة قلاع دلهي كفيل للمرء بأن يدرك إلى أي مدى يمكن للعمارة أن تصله. هذه مبانٍ من رخام وحجر حوَّلتها يد الإنسان الماهر إلى أعمال تكاد من حسنها تنطق شعرًا. قبة سلطانية في بلاد فارس بناءٌ مهيبٌ ارتفاعًا وزخرفًا وإنشاءً. هذه القبة من ضمن الأعلى في تاريخ العمارة الإسلامية، وقد بناها الإمبراطور المغولي محمد خودابند عام 1304 للميلاد، بعد اعتناقه الإسلام. هذا البناء الفرد محاط اليوم بأطلال المدينة التي بُني ضمن نسيجها، والتي يحمل اسمها كعاصمة ثانية للأليخانات المغول. مشهد القبة في سياقها البانورامي ذلك، وهي تشرئب فوق أطلال المدينة، يعكس صورة جلية لمفهوم عمارة الدولة. فقد اختزل عصر الأليخانات بمجمله في هذا البناء (هناك أبنية تتناثر هنا وهناك، لكنها لا تقارن من حيث الحجم والأهمية بقبة سلطانية). يبدو وكأن وجود الدولة حدث عارض في تاريخ الإسلام، وقد أسهب محمد جابر الأنصاري في تحليل سوسيولوجية الدولة في الإسلام. قبة سلطانية بمشهدها الطبيعي اليوم مثال حيّ على عمارة الدولة في الإسلام، من حيث القدرة على البنيان وسرعة الزوال. وإذا كانت قبة سلطانية مثالًا جليًّا لقدرة الدولة على البناء وسرعة زوالها، فإن العمارة العثمانية مثال آخر لعمارة الدولة، لكنه مثال مختلف هذه المرة. هذا ما ستكون لنا معه وقفة مفصَّلة في المقال القادم.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
الجوهر في رأي أرسطو هو الشيء المستقل عن ذاته، المستغني عما سواه. إنه فرد. إنه جوهر. والجوهر هو ما لا يمكن إرجاعه إلى ما هو أقل منه. وجوهر الشيء ماهيته وهو مصدر كل شيء فيه. والجوهر معطى أولي، وما اختلاف الأشياء إلا نتيجة لاختلاف جواهرها. ويتصل بمفهوم الجوهر مفهوم الصورة. وهناك علاقة ترددية بين الجوهر وصورته. هذان المفهومان مركزيان لفهم العمارة، ليس من باب الفلسفة فقط، ولكن من باب المعرفة التي حان وقت تدريسها في قاعات مراسم التصميم المعماري. كيف يمكن لنا ضمن هذا التعريف المبدئي للجوهر تعريف العمارة؟ هل العمارة جوهر؟ يذكر هذا الطرح بمفهوم الحضارة في المقال السابق. فإذا سمحنا لأنفسنا باعتبار الحضارة جوهرًا، باعتبار أن حضارات العالم تختلف عن بعضها اختلافًا جوهريًّا (مع ما قد يترتب على ذلك من جدل مشروع)، فإننا سنجد أن العمارة ليست بجوهر.

إنها منتج. إنها تابع. إنها متغيّرة بتغيّر الزمان والمكان. إنها وظيفة من وظائف الحضارة، وليس أدل على ذلك من الاختلاف الجلي بين عمائر حضارات العالم؛ إذ دأبت كل موسوعة حضارية بتخصيص فصل مستقل في آخر الموسوعة عن العمارة باعتبارها نتاجًا حضاريًّا. وبقدر ما يبدو هذا الأمر بديهيًّا من وجهة نظر عامة إلا أنه يغيب أو يكاد في خضم الدراسات المختلفة المتعلقة بالعمارة. إن النظر للعمارة باعتبارها منتجًا حضاريًّا يسهل كثيرًا من فهمها مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى بناء عمائر تلبي احتياجات الناس على مختلف الأصعدة. ولذلك.. لفهم العمارة في سياقها الصحيح يجب دراسة الحضارة قبل دراسة العمارة. ولنا في العمارة الغربية بمختلف عصورها ومبانيها ومسمياتها أوضح مثال. فبدون فهم التاريخ اليوناني القديم وسوسيولوجيا المدن – الدول الإغريقية من الصعب فهم عماراتها. يصعب فهم مغزى ما تسميه كلاسيكيات تاريخ العمارة «أنظمة العمارة اليونانية» في قواعد وأبدان وتيجان أعمدتها الثلاثة، فإذا أردت فهم تلك الأنظمة فابحث عن سوسيولوجيا القوم الذين بنوها. وفي السياق ذاته لا يمكن فهم ملعب الكولوزيوم (معناه اللغوي في اللاتينية يعني الضخامة) والحمامات وسائر مباني روما القديمة بدون فهم المجتمع الروماني سوسيولوجيا، والحال ذاته ينطبق على العمارة القوطية التي بلغت الذروة شكلًا ومضمونًا في هيمنة الكنيسة على مفاصل الحياة في أوروبا القرون الوسطى. في هذه الحقب التاريخية اختلفت العمائر باختلاف الحضارات. ولعل أهم ما ميَّز العمارة في هذه الحقب هو في جوهرها. لقد بقيت هذه العمائر تعبّر عن جوهر مجتمعات تلك الحقب. لقد كانت صورًا فيزيائية من الحجر والرخام؛ لما عاشته تلك الحضارات ضمن سياقاتها الثقافية والدينية التي عاشت وفقها. لقد كانت مواضيع تلك العمائر على ارتباط وثيق بين المجتمع والمؤسسة. لقد كانت عمائر تعبِّر عن الحالة الاجتماعية بامتياز. كما أنها تعبير جليّ عن دور المؤسسة (مدنية إغريقية، جمهورية رومانية، كنيسة قوطية) في فن العمارة. هكذا احتفظ جوهر هذه العمارات بأصله. أما اختلاف أشكال (صور، هيئات) هذه العمارات عن بعض، فيستحضر مفهوم الصورة عند أرسطو. فقد كان الجسد الإنساني هو مرجع ووحدة بناء العمارة الإغريقية، وكانت قيم الجمهورية هي الصورة التي عكستها العمارة الرومانية، فيما كان احتلال السماء هو ما جعل الكنيسة تسيطر على أتباعها عبر كاتدرائياتها الفارعة الطول. يُحيلنا مفهوم الصورة ذاك في سياق فن الرسم الحديث إلى صورة البورتريه وصورة اللاندسكيب (مع شديد الاعتذار للغتنا). هذان المصطلحان ليسا فلسفيَّين، لكنهما استخدما للتفريق بين الصورة العمودية والصورة الأفقية. البورتريه هو تصوير الوجوه في لوحة عمودية، أما اللاندسكيب فهو تصوير المناظر الطبيعية في لوحات أفقية.
والانتقال من رسم البورتريه إلى اللاندسكيب واكب تطور فن الرسم في أوروبا منذ عصر النهضة إلى الآن. وبإمكاننا هنا استخدام هذين النوعين من التصوير للمقارنة بين العمارة الغربية والعمارة الإسلامية. هذا ما ستكون لنا معه وقفة في مقالات قادمة.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

إذا كان تعريف العمارة يعني جردًا للأبنية التي بُنيت في حقبة تاريخية محددة في بقعة جغرافية محددة، فإن تعريف ابن خلدون للعمارة والعمران عمومًا هو القول الفصل في هذا الخطاب. يربط ابن خلدون في مقدّمته ربطًا وثيقًا بين العمران البشري بمختلف صوره والدولة، فمتى وُجدت الدولة وُجد العمران، وفي غياب الدولة لا وجود للعمران. هذا التعريف يكاد يكون مطابقًا لمفهوم الدولة الإسلامية وارتباط العمارة بها، وهو ما ستكون لنا وقفة معه في مقالات قادمة إن شاء الله. غير أن ارتباط العمارة بالدولة يستدعي البحث في مفهوم الدولة ذاته، في نسبة العمارة للحضارة بمقال سابق، تم الربط بين فكرة الاستقرار طويل الأمد في بقعة جغرافية معينة، وبين ازدهار فن العمارة، وقد كانت أوروبا بما تعاقب فيها من حضارات وعمارات أوضح مثال على ذلك، في هذه الحضارات قد يتطابق مفهوم الدولة مع مفهوم الحضارة، حيث يمكن استخدام أحد المصطلحين نيابة عن الآخر، ولأن العمارة تابعة للدولة أو الحضارة فإن صورتها تتأثر حتمًا بجوهر الدولة، بطبيعتها، بتركيبها الاجتماعية، بأساس وجودها، وهياكلها الاجتماعية والدينية ومنشئها، ووسائل اقتصادها.

ومن هنا اختلفت العمارة من قوم لقوم، ومن دولة لدولة، ومن حقبة تاريخية لحقبة عبر الزمن، لكن يا تُرى هل وجود الدولة ضرورة حتمية لازدهار فن العمارة؟ هنا يأتي مفهوما الصورة والجوهر للإجابة عن هذا السؤال. ربما كانت شبه القارة الهندية (الهند) أوضح مثال في هذا السياق. تُعتبر العمارة الهندوسية حالة خاصة في تاريخ العمارة من عدة أوجه. فبالرغم من تعدد الدول والسلالات الحاكمة التي تعاقبت على حكم شبه القارة إلا أن المجتمع الهندوسي بقي مجتمع قرية أكثر منه مجتمع دولة ذات مدن متعددة. إن معظم مدن الهند تعود إلى فترات متأخرة من تاريخ الهند. لم تكن الدولة في الهند مفهومًا جامعًا لتابعيها أكثر من كونها مناطق نفوذ اسمي لسلالات حاكمة، أو لزعماء قبليين أو لطوائف دينية مهما صغرت. لم تعرف الهند صورة المدينة – الدولة، كما هو الحال عند الإغريق، ناهيك عن فكرة الجمهورية عند الرومان. وبالرغم من ظهور امبراطوريات ضخمة في تاريخ الهند، مثل امبراطورية موراي، وامبراطورية جوبتا منذ القدم، إلا أن العمارة في الهند بقيت عمارة مناطق جغرافية، وزعامات محلية، ومجتمعات قروية أكثر من كونها عمارات دول، وربما كانت الأرواحية وإضفاء القداسة على كل ما دبَّ على وجه الأرض، وقدرة الهندوسية الاستثنائية على امتصاص وتحوير كل معتقد جديد أو فكرة ما؛ لتكوين رابطة صلبة بين مفهوم الدولة وأفرادها عائقًا أمام تكوين امبراطوريات ضخمة في تلك الأرض الشاسعة ذات الموارد الطبيعية الوفيرة. لقد حبَّت الجغرافيا الهند بمقوّمات فريدة جعلت منها إحدى أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان واستقرارًا بشريًّا غاية في القِدَم، ومع ذلك فإن هناك بونًا شاسعًا بين تلك المعطيات الجغرافية، وبين فكرة الدولة ككيان سياسي اجتماعي اقتصادي يجمع بين كافة أفراده. لقد بقي المجتمع الهندوسي مجتمع قرى لا مجتمع مدن، وهنا تأتي العمارة الهندية لتعبّر عن ذلك أبلغ تعبير. في المعابد الهندوسية، لا مكان لفكرة الفراغ الجامع للناس، المعبد الهندوسي هو عمل أقرب ما يكون إلى الإعجاز في النحت أولًا وأخيرًا على أسس رياضية مستمدة من الرياضيات الهندوسية ومشحونة برمزية دينية. المعبد الهندوسي في هيئته وتفاصيله، وفي الجهد الذي يُبذل في قطع الحجارة من جبال وتحويلها إلى ما يُشبه أعمالًا ضخمة من النحت يبقى حالة خاصة في العمارة وارتباطها بأصحابها. هذه الحرفية الماهرة في نحت الحجر المستقلة تمامًا عن أي وجود للدولة تحوَّلت بوجود الدولة (في عهد سلاطين دلهي وفي عهد المغول) إلى واحدة من ألمع فترات العمارة الإسلامية وارتباطها بالدولة. هكذا تتحوَّل العمارة في سياقات المفاهيم الكبرى التي تسيرها.
أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
في مقالَين سابقَين، خلصنا إلى أن الحضارة والدولة معطيان أوليَّان لازدهار العمارة، وهنا تأتي العمارة كتحصيل حاصل لكلا المفهومين. لكن هناك حضورًا فاعلًا للعمارة لا علاقة له بالحضارة ولا الثقافة – بالمعنى المتفق عليه في التاريخ الإنساني – في معظم أنحاء العالم. العمارة التقليدية أو العامية مصطلح تم التعارف عليه عُرفًا وتقليدًا على أنه عمارة المجتمعات ما قبل إنشاء الدولة. وإذا ما تم الاتفاق ولو مبدئيًّا على هذا التعريف (بالرغم من تعدد مرادفاته)، فإن العمارة في كثير من أنحاء العالم، ومنها العالم الإسلامي تحديدًا، والجزيرة العربية والمملكة خصوصًا هي عمارة تقليدية بامتياز. والحديث عن العمارة التقليدية على ظهر الكوكب يُحيلنا إلى موسوعة أوليفر (PAUL OLIVER) Encyclopaedia of vernacular architecture of the world موسوعة العمارة (العامية) في العالم بأجزائها الثلاثة (متوافرة مجانًا بي دي إف) كأضخم وأشمل عمل في مجاله.

سوى ذلك، فإنه يندر التأليف في العمارات التقليدية حول العالم، وهذا مؤشر بالغ الدلالة في علاقة العمارة بالكتابة، وكأن هناك علاقة خفية بين ضرورة انتماء العمارة لحضارة أو دولة بعينها وتدوينها. وهذا يقودنا إلى العلاقة الوثيقة بين العمارة واللغة، فكما أن عمارة الحضارة والدولة هي العمارة المعترف بها رسميًّا من قبل المؤرخين، وهي ما يتم تدريسه في كليات العمارة، فإن ما يقع خارج نطاق هذين المصطلحين لا يدوَّن. إنه يبقى كاللغة العامية، محكية، لا تلتزم بالنحو والصرف، وغير مدوَّنة. هذه مقاربة بالغة الأهمية بين اللغة والعمارة، وهي تستحق مقالًا خاصًّا. ومن الواضح أننا هنا بصدد الحديث عن مفاهيم معرفية في علوم الإنسانيات وعلم الاجتماع قبل الحديث عن العمارة. ماذا عن عمائر الشعوب التي لم تعرف الحضارة ولم تقم فيها دول؟ ماذا عن شعوب الشمال القطبي، والقبائل المتناثرة في غابات الأمازون وأدغال أفريقيا وأرخبيل الجزر الهندوصينية؟ ماذا عن البدو الرحالة في السهوب الآسيوية، وماذا عن عمائر المجتمعات الجبلية المعزولة جغرافيًّا كالتبت وهندوكوش ومرتفعات الأنديز في أمريكا الجنوبية. نحت الأسكيمو من الثلج بيوتًا لهم، تمامًا كما فعل كثير من قبائل البربر في شمال أفريقيا (مطماطة في تونس كمثال)، وتبدو قرى قبائل الدوجون في أكناف الجبال في مالي مشابهة لمثيلات لها في صحاري أمريكا ما قبل كولومبوس. وفي غياهب مجتمعات الأمازون تبني القبائل البدائية عمائر من أشجار الغاب فريدة في العمارة كمساكن جماعية لكل أفراد القبيلة. والحال ذاته ينطبق على مجتمعات القارة السمراء التي تتعدد عمائرها بتعدد قبائلها. وتعتبر مساجد الطين في دول الصحراء الكبرى، وهي تُعدُّ بالآلاف أعمالًا مدهشة في فن التكوين بالطين. وفي السهوب الآسيوية تأتي خيام البدو الرحّالة المقاومة للبرد والمقفلة تمامًا في أشكال لا حصر لها. وتبقى إندونيسيا بجزرها وثقافاتها المتعددة حالة خاصة في تعدد أشكال عمائرها. عمائر هذه الثقافات من حيث التصنيف المعماري لها كهيئات (أشكال)، ومحتوى ومعنى وتكوينات اجتماعية واستدامة على درجة عالية من التصنيف أين منها عمائر الدول والحضارات، ومع ذلك تبقى هذه العمارات مجهولة إلا للمختصين في حقول الدراسات الإنثروبولوجية. هذه العمارات تُعيد طرح مفهوم العمارة للنقاش من جديد.
هكذا أصبحنا أمام ثلاث حالات من العمارة كنتاج لمعطيات تاريخية وجغرافية بعينها. هذا التصنيف في غاية الأهمية؛ لأنه سوف يساعد المهتمين بالعمارة، كلًّا في مجال تخصصه على النظر للعمارة في سياقها الخاص بها الذي أنتجها. ربما كانت العمارة الإسلامية على وجه التحديد هي المجال المعنيّ بهذا التصنيف؛ لكونها تشمل هذه السياقات، وما لم يتم الفصل بينها كلّ في سياقه، فإن ذلك يؤدي إلى اختلاط المفاهيم، وهذا ما ستكون لنا معه وقفات مفصَّلة في المقالات القادمة إن شاء الله.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
في مقالَين سابقَين، خلصنا إلى أن الحضارة والدولة معطيان أوليَّان لازدهار العمارة، وهنا تأتي العمارة كتحصيل حاصل لكلا المفهومين. لكن هناك حضورًا فاعلًا للعمارة لا علاقة له بالحضارة ولا الثقافة – بالمعنى المتفق عليه في التاريخ الإنساني – في معظم أنحاء العالم. العمارة التقليدية أو العامية مصطلح تم التعارف عليه عُرفًا وتقليدًا على أنه عمارة المجتمعات ما قبل إنشاء الدولة. وإذا ما تم الاتفاق ولو مبدئيًّا على هذا التعريف (بالرغم من تعدد مرادفاته)، فإن العمارة في كثير من أنحاء العالم، ومنها العالم الإسلامي تحديدًا، والجزيرة العربية والمملكة خصوصًا هي عمارة تقليدية بامتياز. والحديث عن العمارة التقليدية على ظهر الكوكب يُحيلنا إلى موسوعة أوليفر (PAUL OLIVER) Encyclopaedia of vernacular architecture of the world موسوعة العمارة (العامية) في العالم بأجزائها الثلاثة (متوافرة مجانًا بي دي إف) كأضخم وأشمل عمل في مجاله.

سوى ذلك، فإنه يندر التأليف في العمارات التقليدية حول العالم، وهذا مؤشر بالغ الدلالة في علاقة العمارة بالكتابة، وكأن هناك علاقة خفية بين ضرورة انتماء العمارة لحضارة أو دولة بعينها وتدوينها. وهذا يقودنا إلى العلاقة الوثيقة بين العمارة واللغة، فكما أن عمارة الحضارة والدولة هي العمارة المعترف بها رسميًّا من قبل المؤرخين، وهي ما يتم تدريسه في كليات العمارة، فإن ما يقع خارج نطاق هذين المصطلحين لا يدوَّن. إنه يبقى كاللغة العامية، محكية، لا تلتزم بالنحو والصرف، وغير مدوَّنة. هذه مقاربة بالغة الأهمية بين اللغة والعمارة، وهي تستحق مقالًا خاصًّا. ومن الواضح أننا هنا بصدد الحديث عن مفاهيم معرفية في علوم الإنسانيات وعلم الاجتماع قبل الحديث عن العمارة. ماذا عن عمائر الشعوب التي لم تعرف الحضارة ولم تقم فيها دول؟ ماذا عن شعوب الشمال القطبي، والقبائل المتناثرة في غابات الأمازون وأدغال أفريقيا وأرخبيل الجزر الهندوصينية؟ ماذا عن البدو الرحالة في السهوب الآسيوية، وماذا عن عمائر المجتمعات الجبلية المعزولة جغرافيًّا كالتبت وهندوكوش ومرتفعات الأنديز في أمريكا الجنوبية. نحت الأسكيمو من الثلج بيوتًا لهم، تمامًا كما فعل كثير من قبائل البربر في شمال أفريقيا (مطماطة في تونس كمثال)، وتبدو قرى قبائل الدوجون في أكناف الجبال في مالي مشابهة لمثيلات لها في صحاري أمريكا ما قبل كولومبوس. وفي غياهب مجتمعات الأمازون تبني القبائل البدائية عمائر من أشجار الغاب فريدة في العمارة كمساكن جماعية لكل أفراد القبيلة. والحال ذاته ينطبق على مجتمعات القارة السمراء التي تتعدد عمائرها بتعدد قبائلها. وتعتبر مساجد الطين في دول الصحراء الكبرى، وهي تُعدُّ بالآلاف أعمالًا مدهشة في فن التكوين بالطين. وفي السهوب الآسيوية تأتي خيام البدو الرحّالة المقاومة للبرد والمقفلة تمامًا في أشكال لا حصر لها. وتبقى إندونيسيا بجزرها وثقافاتها المتعددة حالة خاصة في تعدد أشكال عمائرها. عمائر هذه الثقافات من حيث التصنيف المعماري لها كهيئات (أشكال)، ومحتوى ومعنى وتكوينات اجتماعية واستدامة على درجة عالية من التصنيف أين منها عمائر الدول والحضارات، ومع ذلك تبقى هذه العمارات مجهولة إلا للمختصين في حقول الدراسات الإنثروبولوجية. هذه العمارات تُعيد طرح مفهوم العمارة للنقاش من جديد.
هكذا أصبحنا أمام ثلاث حالات من العمارة كنتاج لمعطيات تاريخية وجغرافية بعينها. هذا التصنيف في غاية الأهمية؛ لأنه سوف يساعد المهتمين بالعمارة، كلًّا في مجال تخصصه على النظر للعمارة في سياقها الخاص بها الذي أنتجها. ربما كانت العمارة الإسلامية على وجه التحديد هي المجال المعنيّ بهذا التصنيف؛ لكونها تشمل هذه السياقات، وما لم يتم الفصل بينها كلّ في سياقه، فإن ذلك يؤدي إلى اختلاط المفاهيم، وهذا ما ستكون لنا معه وقفات مفصَّلة في المقالات القادمة إن شاء الله.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
في مقالَين سابقَين، خلصنا إلى أن الحضارة والدولة معطيان أوليَّان لازدهار العمارة، وهنا تأتي العمارة كتحصيل حاصل لكلا المفهومين. لكن هناك حضورًا فاعلًا للعمارة لا علاقة له بالحضارة ولا الثقافة – بالمعنى المتفق عليه في التاريخ الإنساني – في معظم أنحاء العالم. العمارة التقليدية أو العامية مصطلح تم التعارف عليه عُرفًا وتقليدًا على أنه عمارة المجتمعات ما قبل إنشاء الدولة. وإذا ما تم الاتفاق ولو مبدئيًّا على هذا التعريف (بالرغم من تعدد مرادفاته)، فإن العمارة في كثير من أنحاء العالم، ومنها العالم الإسلامي تحديدًا، والجزيرة العربية والمملكة خصوصًا هي عمارة تقليدية بامتياز. والحديث عن العمارة التقليدية على ظهر الكوكب يُحيلنا إلى موسوعة أوليفر (PAUL OLIVER) Encyclopaedia of vernacular architecture of the world موسوعة العمارة (العامية) في العالم بأجزائها الثلاثة (متوافرة مجانًا بي دي إف) كأضخم وأشمل عمل في مجاله.

سوى ذلك، فإنه يندر التأليف في العمارات التقليدية حول العالم، وهذا مؤشر بالغ الدلالة في علاقة العمارة بالكتابة، وكأن هناك علاقة خفية بين ضرورة انتماء العمارة لحضارة أو دولة بعينها وتدوينها. وهذا يقودنا إلى العلاقة الوثيقة بين العمارة واللغة، فكما أن عمارة الحضارة والدولة هي العمارة المعترف بها رسميًّا من قبل المؤرخين، وهي ما يتم تدريسه في كليات العمارة، فإن ما يقع خارج نطاق هذين المصطلحين لا يدوَّن. إنه يبقى كاللغة العامية، محكية، لا تلتزم بالنحو والصرف، وغير مدوَّنة. هذه مقاربة بالغة الأهمية بين اللغة والعمارة، وهي تستحق مقالًا خاصًّا. ومن الواضح أننا هنا بصدد الحديث عن مفاهيم معرفية في علوم الإنسانيات وعلم الاجتماع قبل الحديث عن العمارة. ماذا عن عمائر الشعوب التي لم تعرف الحضارة ولم تقم فيها دول؟ ماذا عن شعوب الشمال القطبي، والقبائل المتناثرة في غابات الأمازون وأدغال أفريقيا وأرخبيل الجزر الهندوصينية؟ ماذا عن البدو الرحالة في السهوب الآسيوية، وماذا عن عمائر المجتمعات الجبلية المعزولة جغرافيًّا كالتبت وهندوكوش ومرتفعات الأنديز في أمريكا الجنوبية. نحت الأسكيمو من الثلج بيوتًا لهم، تمامًا كما فعل كثير من قبائل البربر في شمال أفريقيا (مطماطة في تونس كمثال)، وتبدو قرى قبائل الدوجون في أكناف الجبال في مالي مشابهة لمثيلات لها في صحاري أمريكا ما قبل كولومبوس. وفي غياهب مجتمعات الأمازون تبني القبائل البدائية عمائر من أشجار الغاب فريدة في العمارة كمساكن جماعية لكل أفراد القبيلة. والحال ذاته ينطبق على مجتمعات القارة السمراء التي تتعدد عمائرها بتعدد قبائلها. وتعتبر مساجد الطين في دول الصحراء الكبرى، وهي تُعدُّ بالآلاف أعمالًا مدهشة في فن التكوين بالطين. وفي السهوب الآسيوية تأتي خيام البدو الرحّالة المقاومة للبرد والمقفلة تمامًا في أشكال لا حصر لها. وتبقى إندونيسيا بجزرها وثقافاتها المتعددة حالة خاصة في تعدد أشكال عمائرها. عمائر هذه الثقافات من حيث التصنيف المعماري لها كهيئات (أشكال)، ومحتوى ومعنى وتكوينات اجتماعية واستدامة على درجة عالية من التصنيف أين منها عمائر الدول والحضارات، ومع ذلك تبقى هذه العمارات مجهولة إلا للمختصين في حقول الدراسات الإنثروبولوجية. هذه العمارات تُعيد طرح مفهوم العمارة للنقاش من جديد.
هكذا أصبحنا أمام ثلاث حالات من العمارة كنتاج لمعطيات تاريخية وجغرافية بعينها. هذا التصنيف في غاية الأهمية؛ لأنه سوف يساعد المهتمين بالعمارة، كلًّا في مجال تخصصه على النظر للعمارة في سياقها الخاص بها الذي أنتجها. ربما كانت العمارة الإسلامية على وجه التحديد هي المجال المعنيّ بهذا التصنيف؛ لكونها تشمل هذه السياقات، وما لم يتم الفصل بينها كلّ في سياقه، فإن ذلك يؤدي إلى اختلاط المفاهيم، وهذا ما ستكون لنا معه وقفات مفصَّلة في المقالات القادمة إن شاء الله.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
في مقالَين سابقَين، خلصنا إلى أن الحضارة والدولة معطيان أوليَّان لازدهار العمارة، وهنا تأتي العمارة كتحصيل حاصل لكلا المفهومين. لكن هناك حضورًا فاعلًا للعمارة لا علاقة له بالحضارة ولا الثقافة – بالمعنى المتفق عليه في التاريخ الإنساني – في معظم أنحاء العالم. العمارة التقليدية أو العامية مصطلح تم التعارف عليه عُرفًا وتقليدًا على أنه عمارة المجتمعات ما قبل إنشاء الدولة. وإذا ما تم الاتفاق ولو مبدئيًّا على هذا التعريف (بالرغم من تعدد مرادفاته)، فإن العمارة في كثير من أنحاء العالم، ومنها العالم الإسلامي تحديدًا، والجزيرة العربية والمملكة خصوصًا هي عمارة تقليدية بامتياز. والحديث عن العمارة التقليدية على ظهر الكوكب يُحيلنا إلى موسوعة أوليفر (PAUL OLIVER) Encyclopaedia of vernacular architecture of the world موسوعة العمارة (العامية) في العالم بأجزائها الثلاثة (متوافرة مجانًا بي دي إف) كأضخم وأشمل عمل في مجاله.

سوى ذلك، فإنه يندر التأليف في العمارات التقليدية حول العالم، وهذا مؤشر بالغ الدلالة في علاقة العمارة بالكتابة، وكأن هناك علاقة خفية بين ضرورة انتماء العمارة لحضارة أو دولة بعينها وتدوينها. وهذا يقودنا إلى العلاقة الوثيقة بين العمارة واللغة، فكما أن عمارة الحضارة والدولة هي العمارة المعترف بها رسميًّا من قبل المؤرخين، وهي ما يتم تدريسه في كليات العمارة، فإن ما يقع خارج نطاق هذين المصطلحين لا يدوَّن. إنه يبقى كاللغة العامية، محكية، لا تلتزم بالنحو والصرف، وغير مدوَّنة. هذه مقاربة بالغة الأهمية بين اللغة والعمارة، وهي تستحق مقالًا خاصًّا. ومن الواضح أننا هنا بصدد الحديث عن مفاهيم معرفية في علوم الإنسانيات وعلم الاجتماع قبل الحديث عن العمارة. ماذا عن عمائر الشعوب التي لم تعرف الحضارة ولم تقم فيها دول؟ ماذا عن شعوب الشمال القطبي، والقبائل المتناثرة في غابات الأمازون وأدغال أفريقيا وأرخبيل الجزر الهندوصينية؟ ماذا عن البدو الرحالة في السهوب الآسيوية، وماذا عن عمائر المجتمعات الجبلية المعزولة جغرافيًّا كالتبت وهندوكوش ومرتفعات الأنديز في أمريكا الجنوبية. نحت الأسكيمو من الثلج بيوتًا لهم، تمامًا كما فعل كثير من قبائل البربر في شمال أفريقيا (مطماطة في تونس كمثال)، وتبدو قرى قبائل الدوجون في أكناف الجبال في مالي مشابهة لمثيلات لها في صحاري أمريكا ما قبل كولومبوس. وفي غياهب مجتمعات الأمازون تبني القبائل البدائية عمائر من أشجار الغاب فريدة في العمارة كمساكن جماعية لكل أفراد القبيلة. والحال ذاته ينطبق على مجتمعات القارة السمراء التي تتعدد عمائرها بتعدد قبائلها. وتعتبر مساجد الطين في دول الصحراء الكبرى، وهي تُعدُّ بالآلاف أعمالًا مدهشة في فن التكوين بالطين. وفي السهوب الآسيوية تأتي خيام البدو الرحّالة المقاومة للبرد والمقفلة تمامًا في أشكال لا حصر لها. وتبقى إندونيسيا بجزرها وثقافاتها المتعددة حالة خاصة في تعدد أشكال عمائرها. عمائر هذه الثقافات من حيث التصنيف المعماري لها كهيئات (أشكال)، ومحتوى ومعنى وتكوينات اجتماعية واستدامة على درجة عالية من التصنيف أين منها عمائر الدول والحضارات، ومع ذلك تبقى هذه العمارات مجهولة إلا للمختصين في حقول الدراسات الإنثروبولوجية. هذه العمارات تُعيد طرح مفهوم العمارة للنقاش من جديد.
هكذا أصبحنا أمام ثلاث حالات من العمارة كنتاج لمعطيات تاريخية وجغرافية بعينها. هذا التصنيف في غاية الأهمية؛ لأنه سوف يساعد المهتمين بالعمارة، كلًّا في مجال تخصصه على النظر للعمارة في سياقها الخاص بها الذي أنتجها. ربما كانت العمارة الإسلامية على وجه التحديد هي المجال المعنيّ بهذا التصنيف؛ لكونها تشمل هذه السياقات، وما لم يتم الفصل بينها كلّ في سياقه، فإن ذلك يؤدي إلى اختلاط المفاهيم، وهذا ما ستكون لنا معه وقفات مفصَّلة في المقالات القادمة إن شاء الله.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
في مقالَين سابقَين، خلصنا إلى أن الحضارة والدولة معطيان أوليَّان لازدهار العمارة، وهنا تأتي العمارة كتحصيل حاصل لكلا المفهومين. لكن هناك حضورًا فاعلًا للعمارة لا علاقة له بالحضارة ولا الثقافة – بالمعنى المتفق عليه في التاريخ الإنساني – في معظم أنحاء العالم. العمارة التقليدية أو العامية مصطلح تم التعارف عليه عُرفًا وتقليدًا على أنه عمارة المجتمعات ما قبل إنشاء الدولة. وإذا ما تم الاتفاق ولو مبدئيًّا على هذا التعريف (بالرغم من تعدد مرادفاته)، فإن العمارة في كثير من أنحاء العالم، ومنها العالم الإسلامي تحديدًا، والجزيرة العربية والمملكة خصوصًا هي عمارة تقليدية بامتياز. والحديث عن العمارة التقليدية على ظهر الكوكب يُحيلنا إلى موسوعة أوليفر (PAUL OLIVER) Encyclopaedia of vernacular architecture of the world موسوعة العمارة (العامية) في العالم بأجزائها الثلاثة (متوافرة مجانًا بي دي إف) كأضخم وأشمل عمل في مجاله.

سوى ذلك، فإنه يندر التأليف في العمارات التقليدية حول العالم، وهذا مؤشر بالغ الدلالة في علاقة العمارة بالكتابة، وكأن هناك علاقة خفية بين ضرورة انتماء العمارة لحضارة أو دولة بعينها وتدوينها. وهذا يقودنا إلى العلاقة الوثيقة بين العمارة واللغة، فكما أن عمارة الحضارة والدولة هي العمارة المعترف بها رسميًّا من قبل المؤرخين، وهي ما يتم تدريسه في كليات العمارة، فإن ما يقع خارج نطاق هذين المصطلحين لا يدوَّن. إنه يبقى كاللغة العامية، محكية، لا تلتزم بالنحو والصرف، وغير مدوَّنة. هذه مقاربة بالغة الأهمية بين اللغة والعمارة، وهي تستحق مقالًا خاصًّا. ومن الواضح أننا هنا بصدد الحديث عن مفاهيم معرفية في علوم الإنسانيات وعلم الاجتماع قبل الحديث عن العمارة. ماذا عن عمائر الشعوب التي لم تعرف الحضارة ولم تقم فيها دول؟ ماذا عن شعوب الشمال القطبي، والقبائل المتناثرة في غابات الأمازون وأدغال أفريقيا وأرخبيل الجزر الهندوصينية؟ ماذا عن البدو الرحالة في السهوب الآسيوية، وماذا عن عمائر المجتمعات الجبلية المعزولة جغرافيًّا كالتبت وهندوكوش ومرتفعات الأنديز في أمريكا الجنوبية. نحت الأسكيمو من الثلج بيوتًا لهم، تمامًا كما فعل كثير من قبائل البربر في شمال أفريقيا (مطماطة في تونس كمثال)، وتبدو قرى قبائل الدوجون في أكناف الجبال في مالي مشابهة لمثيلات لها في صحاري أمريكا ما قبل كولومبوس. وفي غياهب مجتمعات الأمازون تبني القبائل البدائية عمائر من أشجار الغاب فريدة في العمارة كمساكن جماعية لكل أفراد القبيلة. والحال ذاته ينطبق على مجتمعات القارة السمراء التي تتعدد عمائرها بتعدد قبائلها. وتعتبر مساجد الطين في دول الصحراء الكبرى، وهي تُعدُّ بالآلاف أعمالًا مدهشة في فن التكوين بالطين. وفي السهوب الآسيوية تأتي خيام البدو الرحّالة المقاومة للبرد والمقفلة تمامًا في أشكال لا حصر لها. وتبقى إندونيسيا بجزرها وثقافاتها المتعددة حالة خاصة في تعدد أشكال عمائرها. عمائر هذه الثقافات من حيث التصنيف المعماري لها كهيئات (أشكال)، ومحتوى ومعنى وتكوينات اجتماعية واستدامة على درجة عالية من التصنيف أين منها عمائر الدول والحضارات، ومع ذلك تبقى هذه العمارات مجهولة إلا للمختصين في حقول الدراسات الإنثروبولوجية. هذه العمارات تُعيد طرح مفهوم العمارة للنقاش من جديد.
هكذا أصبحنا أمام ثلاث حالات من العمارة كنتاج لمعطيات تاريخية وجغرافية بعينها. هذا التصنيف في غاية الأهمية؛ لأنه سوف يساعد المهتمين بالعمارة، كلًّا في مجال تخصصه على النظر للعمارة في سياقها الخاص بها الذي أنتجها. ربما كانت العمارة الإسلامية على وجه التحديد هي المجال المعنيّ بهذا التصنيف؛ لكونها تشمل هذه السياقات، وما لم يتم الفصل بينها كلّ في سياقه، فإن ذلك يؤدي إلى اختلاط المفاهيم، وهذا ما ستكون لنا معه وقفات مفصَّلة في المقالات القادمة إن شاء الله.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
في مقالَين سابقَين، خلصنا إلى أن الحضارة والدولة معطيان أوليَّان لازدهار العمارة، وهنا تأتي العمارة كتحصيل حاصل لكلا المفهومين. لكن هناك حضورًا فاعلًا للعمارة لا علاقة له بالحضارة ولا الثقافة – بالمعنى المتفق عليه في التاريخ الإنساني – في معظم أنحاء العالم. العمارة التقليدية أو العامية مصطلح تم التعارف عليه عُرفًا وتقليدًا على أنه عمارة المجتمعات ما قبل إنشاء الدولة. وإذا ما تم الاتفاق ولو مبدئيًّا على هذا التعريف (بالرغم من تعدد مرادفاته)، فإن العمارة في كثير من أنحاء العالم، ومنها العالم الإسلامي تحديدًا، والجزيرة العربية والمملكة خصوصًا هي عمارة تقليدية بامتياز. والحديث عن العمارة التقليدية على ظهر الكوكب يُحيلنا إلى موسوعة أوليفر (PAUL OLIVER) Encyclopaedia of vernacular architecture of the world موسوعة العمارة (العامية) في العالم بأجزائها الثلاثة (متوافرة مجانًا بي دي إف) كأضخم وأشمل عمل في مجاله.

سوى ذلك، فإنه يندر التأليف في العمارات التقليدية حول العالم، وهذا مؤشر بالغ الدلالة في علاقة العمارة بالكتابة، وكأن هناك علاقة خفية بين ضرورة انتماء العمارة لحضارة أو دولة بعينها وتدوينها. وهذا يقودنا إلى العلاقة الوثيقة بين العمارة واللغة، فكما أن عمارة الحضارة والدولة هي العمارة المعترف بها رسميًّا من قبل المؤرخين، وهي ما يتم تدريسه في كليات العمارة، فإن ما يقع خارج نطاق هذين المصطلحين لا يدوَّن. إنه يبقى كاللغة العامية، محكية، لا تلتزم بالنحو والصرف، وغير مدوَّنة. هذه مقاربة بالغة الأهمية بين اللغة والعمارة، وهي تستحق مقالًا خاصًّا. ومن الواضح أننا هنا بصدد الحديث عن مفاهيم معرفية في علوم الإنسانيات وعلم الاجتماع قبل الحديث عن العمارة. ماذا عن عمائر الشعوب التي لم تعرف الحضارة ولم تقم فيها دول؟ ماذا عن شعوب الشمال القطبي، والقبائل المتناثرة في غابات الأمازون وأدغال أفريقيا وأرخبيل الجزر الهندوصينية؟ ماذا عن البدو الرحالة في السهوب الآسيوية، وماذا عن عمائر المجتمعات الجبلية المعزولة جغرافيًّا كالتبت وهندوكوش ومرتفعات الأنديز في أمريكا الجنوبية. نحت الأسكيمو من الثلج بيوتًا لهم، تمامًا كما فعل كثير من قبائل البربر في شمال أفريقيا (مطماطة في تونس كمثال)، وتبدو قرى قبائل الدوجون في أكناف الجبال في مالي مشابهة لمثيلات لها في صحاري أمريكا ما قبل كولومبوس. وفي غياهب مجتمعات الأمازون تبني القبائل البدائية عمائر من أشجار الغاب فريدة في العمارة كمساكن جماعية لكل أفراد القبيلة. والحال ذاته ينطبق على مجتمعات القارة السمراء التي تتعدد عمائرها بتعدد قبائلها. وتعتبر مساجد الطين في دول الصحراء الكبرى، وهي تُعدُّ بالآلاف أعمالًا مدهشة في فن التكوين بالطين. وفي السهوب الآسيوية تأتي خيام البدو الرحّالة المقاومة للبرد والمقفلة تمامًا في أشكال لا حصر لها. وتبقى إندونيسيا بجزرها وثقافاتها المتعددة حالة خاصة في تعدد أشكال عمائرها. عمائر هذه الثقافات من حيث التصنيف المعماري لها كهيئات (أشكال)، ومحتوى ومعنى وتكوينات اجتماعية واستدامة على درجة عالية من التصنيف أين منها عمائر الدول والحضارات، ومع ذلك تبقى هذه العمارات مجهولة إلا للمختصين في حقول الدراسات الإنثروبولوجية. هذه العمارات تُعيد طرح مفهوم العمارة للنقاش من جديد.
هكذا أصبحنا أمام ثلاث حالات من العمارة كنتاج لمعطيات تاريخية وجغرافية بعينها. هذا التصنيف في غاية الأهمية؛ لأنه سوف يساعد المهتمين بالعمارة، كلًّا في مجال تخصصه على النظر للعمارة في سياقها الخاص بها الذي أنتجها. ربما كانت العمارة الإسلامية على وجه التحديد هي المجال المعنيّ بهذا التصنيف؛ لكونها تشمل هذه السياقات، وما لم يتم الفصل بينها كلّ في سياقه، فإن ذلك يؤدي إلى اختلاط المفاهيم، وهذا ما ستكون لنا معه وقفات مفصَّلة في المقالات القادمة إن شاء الله.
* أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.